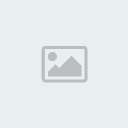<H2 dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify">لنفرح بالعيد
أما بالنسبة لنا، فقد جاءنا العيد.
لقد جاء اليوم المقدس الذي يلزمنا فيه أن نبوق داعين إلى العيد. ونفصل أنفسنا للرب بالشكر، ناظرين إلى أن هذا العيد هو عيدنا نحن. لأننا قد صار علينا أن نقدسه، لا لأنفسنا بل للرب، وأن نفرح فيه لا في أنفسنا بل في الرب، الذي حمل أحزاننا قائلاً "نفسي حزينة جدًا حتى الموت"(2).
فالوثنيين وكل الغرباء عن الإيمان يحفظون الأعياد لإرادتهم الذاتية، هؤلاء ليس لهم سلام إذ يرتكبون الشر في حق الله.
أما القديسون فإذ يعيشون للرب يحفظون العيد، فيقول كل منهم "مبتهجًا بخلاصك"، "أما نفسي فتفرح بالرب"(3).
فالوصية عامة بأن يفرح الأبرار بالرب، حتى إذ يجتمعون معًا يترنمون بذلك المزمور الخاص بالعيد وهو عام للجميع، قائلين "هلم نرنم للرب"(4) وليس لأنفسنا.
بين ذبح اسحق وذبح المسيح
هكذا فرح إبراهيم إذ رأى يوم الرب، لا يوم نفسه. تطلع إلى قدام فرأى يوم الرب ففرح(1).
وعندما جرب، قدم بالإيمان اسحق جاعلاً من ابنه الوحيد الذي نال فيه المواعيد ذبيحة. ولما منع من ذبحه تطلع فرأى المسيا في "الخروف"(2) الذي ذبح لله عوضًا عن ابنه.
لقد جرب الأب في ابنه، ولم يكن الذبح أمر بغير معنى، إنما كان فيه إشارة إلى الرب كما في إشعياء إذ يقول "كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه"(3)، إنما قد حمل خطايا العالم.
على هذا الأساس منع إبراهيم من أن يمد يده على الصبي، حتى لا يستغلها اليهود كفرصة ليزدروا بالصوت النبوي الذي ينطق بخصوص مخلصنا ناسبين إياه إلى ذبح اسحق، حاسبين أن كل هذا يشير إلى ابن إبراهيم.
ذبيحة اسحق مجرد رمز
لم تكن الذبيحة (من أجل اسحق)(4)، بل من أجل الذي قدم الذبيحة، إذ بهذا قد جرب. لقد قبل الله إرادة مقدم الذبيجة، لكنه منع تقديم الذبيحة. لأن موت اسحق لا يؤدي إلى تحرير العالم، إنما موت مخلصنا وحده الذي بجراحاته شفينا(5). فقد أقام الساقطين، وشفى المرض، وأشبع الجياع، وسد أعواز المحتاجين، وما هو أعجب أنه أقامنا نحن الأموات، مبطلاً الموت، محظرًا إيانا من الحزن والتنهد إلى الراحة والسعادة كالتي لهذا العيد، إلى الفرح الذي هو في السموات.
ولسنا نحن وحدنا الذين نتأثر بهذا، بل والسماء أيضًا تفرح معنا مع كل كنيسة الأبكار المكتوبة في السموات(6).
الكل يفرح معًا كما يعلن النبي قائلاً "ترنمي أيتها السموات لأن الرب قد فعل رحمة.. اهتفي يا أسافل الأرض. أشيدي أيتها الجبال ترنمًا، الوعر وكل شجرة فيه لأن الرب قد فدى يعقوب.
ومرة أخرى يقول "ترنمي أيتها السموات وابتهجي أيتها الأرض. لنشيد الجبال بالترنم لأن الرب قد عزى شعبه وعلى يائسيه يترحم"(1).
فرح في السماء وعلى الأرض
إذًا الخليقة كلها تحفظ عيدًا يا أخوتي، وكل نسمة تسبح الرب كقول المرتل(2)، وذلك بسبب هلاك الأعداء (الشياطين) وخلاصنا.
بالحق أن كان في توبة الخاطئ يكون فرح في السماء(3)، فكيف لا يكون فرح بسبب إبطال الخطية وإقامة الأموات؟!
آه. يا له من عيد وفرح في السماء!!
حقًا. كيف تفرح كل الطغمات السمائية وتبتهج، إذ يفرحوا ويسهروا في اجتماعاتنا ويأتون إلينا فيكونون معنا دائمًا، خاصة في أيام عيد القيامة؟!
أنهم يتطلعون إلى الخطاة وهم يتوبون.
وإلى الذين يحولون وجوههم (عن الخطية) ويتغيرون، وإلى الذين كانوا غرقى في الشهوات والترف والآن هم منسحقون بالأصوام والعفة.
وأخيرًا يتطلعون إلى العدو (الشيطان) وهو مطروح ضعيفًا بلا حياة، مربوط الأيدي والأقدام، فنسخر منه قائلين: "أين شوكتك يا موت. أين غلبتك يا هاوية" (1 كو 55:15).
فلنترنم الآن للرب بأغنية النصرة.
من هم الذين يعبدون؟
من هو هذا الذي إذ يأتي مشتاقًا إلى عيد سماوي ويوم ملائكي، يقول مثل النبي "فآتي إلى مذبح الله، إلى الله، بهجة فرحي، وأحمدك بالعود يا الله إلهي"(5).
والقديسون يشجعوننا أيضًا للسلوك بهذا المسلك قائلين "هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب
لكن هذا العيد ليس لأجل الدنسين، ولا يصعد إليه الأشرار، بل الصالحين والمجاهدين والذين يسلكون بنفس الهدف الذي هو للقديسين، لأنه "من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟! الطاهر اليدين والنقي القلب الذي يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبًا"(1). لأنه كما يكمل المزمور قائلاً "يحمل بركة من عند الرب (وبرًا من إله خلاصه)".
هذا واضح أنه يشير إلى ما يهبه الرب للذين عن يمينه قائلاً "تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم"(2)
أما الإنسان المخادع، وغير نقي القلب، والذي ليس فيه شيئًا طاهرًا… فهذا بالتأكيد غريب عن القديسين… ويحسب غير مستحقًا ليأكل الفصح، لأن "كل ابن غريب لا يأكل منه"(3).
لهذا عندما ظن يهوذا أنه قد حفظ الفصح، بينما كان قد دبر خداعًا ضد المخلص، أصبح غريبًا عن المدينة التي هي من فوق وبعيدًا عن الصحبة الرسولية، لأن الشريعة أمرت أن يؤكل الفصح بحرص لائق، أما هو بينما كان يأكل نفبه الشيطان ودخل إلى نفسه
كيف نعبد؟
ليتنا لا نعيد العيد بطريقة أرضية، بل كمن يحفظ عيدًا في السماء مع الملائكة!
لنمجد الله بحياة العفة والبر والفضائل الأخرى!
لتفرح لا في أنفسنا بل في الرب، فنكون مع القديسين!
لنسهر مع داود الذي قام سبع مرات، وفي نصف الليل كان يقدم الشكر من أجل أحكام الله العادلة!
لنبكر كقول المرتل "يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني"!(5) لنصم مثل دانيال!
لنصلي بلا انقطاع كأمر بولس. فكلنا يعرف موعد الصلاة خاصة المتزوجين زواجًا مكرمًا!
فإذ نحمل شهادة بهذه الأمور، حافظين العيد بهذه الكيفية نستطيع أن ندخل إلى فرح المسيح في ملكوت السموات.
وكما أن إسرائيل (في القديم) عندما صعد إلى أورشليم تنقى في البرية، متدربًا على نسيان العادات (الوثنية) المصرية، هكذا فأن الكلمة وضع لنا هذا الصوم المقدس الذي للأربعين يومًا، فنتنقى ونتحرر من الدنس، حتى عندما نرحل من هنا يمكننا بكوننا قد حرصنا على الصوم (هكذا) أن نصعد إلى جمال الرب العالي، ونتعشى منه، ونكون شركاء في الفرح السماوي.
فأنه لا يمكنك أن تصعد إلى أورشليم وتأكل الفصح دون أن تحفظ صوم الأربعين.</H2>